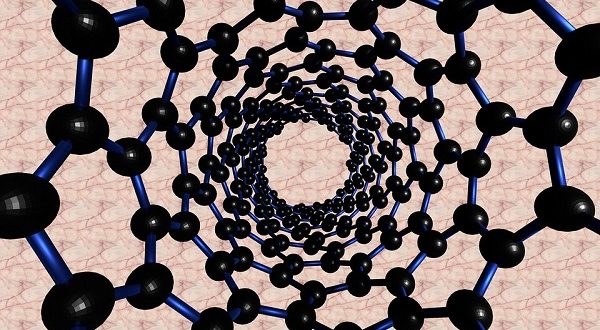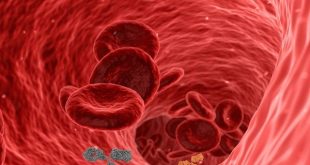تاريخ المجتمع الإنساني وتطوره الحضاري هو بشكل ما تاريخ الأدوات والآلات وتطورها واستخدامها في التغلب على العوائق التي تمنع من إنجاز كثير من الأعمال الشاقة على الوجه الأكمل, بل والاستعانة بها أحيانا في صنع عالم جديد يختلف عن العالم الطبيعي في كثير من الوجوه, ولكنه يحقق قدراً أكبر من متطلبات الإنسان المتزايدة والمتشابكة والمعقدة.
لقد كانت للإنسان دائما القدرة على الاستفادة من الآلات التي يصنعها في ابتكار آلات جديدة أكثر تقدما وقدرة على التحكم في مظاهر البيئة الطبيعية وإعادة تشكيلها وتذليلها لصالحه مما جعل مفكرا مثل بنيامين فرانكلين يفسر الاصطلاح المألوف في الكتابات الأنثربولوجية (الإنسان الصانع) بأنه (صانع الأدوات والآلات), على اعتبار أن ما يميز الإنسان عن بقية الكائنات الحية هو القدرة الواعية على اختراع الآلات لتحقيق أهداف معينة ومحددة, ثم استخدام هذه الآلات لتحقيق تلك الأهداف بالفعل وعلى أرض الواقع, وأن هذه الميزة قد لازمته منذ فجر التاريخ وحتى عصرنا الحالي الذي يطلق عليه بحق اسم (عصر التكنولوجيا) الذي تسيطر فيه المنجزات التكنولوجية المتعددة والمتنوعة على كل شيء, بما فيها الإنسان نفسه الذي توصل إلى صنع تلك التقنيات.
وقد تحقق كل هذا التقدم التكنولوجي نتيجة الاعتماد على المنهج العلمي الدقيق الذي أتاح للمتخصصين في مختلف فروع العلم أن يرتادوا كثيرا من مجالات النشاط البشري في تعامله مع الطبيعة المحيطة به, وأن يسهموا بقسط وافر في إعادة صياغة الأساليب والوسائل والتقنيات البسيطة الساذجة التي كان الإنسان يستخدمها في المراحل السابقة من تاريخ المجتمع الإنساني, وأن يبتكروا وسائل ووسائط وتقنيات جديدة تساعد على تحقيق مزيد من القدرة على التحكم في تلك المجالات المختلفة. وقد سجل عالم الاجتماع الأمريكي روبرت تيزبت إعجابه بما أنجزه التكنولوجيون المعاصرون حين ذكر في كتابه القيم (التقاليد والثورة) أن لكل عصر أبطاله وأن أبطال هذا العصر هم التكنولوجيون بغير منازع. ودفع ذلك بعض المفكرين إلى محاولة وضع تعريف جديد للإنسان في ضوء معطيات العصر, وذهبوا في ذلك إلى أنه إذا كان علماء القرن التاسع عشر والقرن العشرين اهتموا بتحديد علاقة الإنسان مع الفرديات والآدميات الأخرى, فإن الذي يحدد وضعه في القرن الواحد والعشرين هو علاقته بالآلات والأدوات المستجدة, وذلك على أساس أن بعض منجزات التكنولوجيا الحديثة تؤلف جزءا من التكوين الفيزيقي والعقلي للإنسان المعاصر ولإنسان المستقبل.
فإذا كانت النظرة التي سادت في الماضي ترى الأدوات والآلات مجرد امتداد خارجي لبعض أعضاء الجسم وبخاصة اليد, وأن الإنسان صنعها لكي تعطي لأعضائه وحواسّه مزيدا من القوة ومن الدقة والإتقان, فإن بعض المنجزات التكنولوجية الحديثة أو التي يتوقع الوصول إليها في المستقبل القريب سوف يمكن إدخالها في جسم الإنسان بحيث تؤلف جزءا عضويا في تكوينه البشري, وسوف يساعد على إحراز هذا التقدم التطورات التي تتحقق الآن في مجال ما يعرف باسم النانوتكنولوجي nanotechnology أي تكنولوجيا الأشياء الدقيقة والصغيرة للغاية. فالنانو – وهي كلمة من أصل يوناني معناها القزم – تعني الآن في لغة المقاييس – جزءا من البليون (وليس المليون) من المتر. والطريف أنه في مصر – وربما في بعض البلاد العربية الأخرى – يستخدم الناس كلمة (نونو) للطفل الحديث الولادة, ولكل ما هو صغير بشكل واضح أو مبالغ فيه.
فجر النانوتكنولوجي
ويهتم علم النانو بدراسة الجسميات الجزيئية والذرية التي يمكن قياسها بهذه الوحدات المتناهية الصغر, كما تركز معظم بحوث النانوتكنولوجي على صنع وإنتاج الآلات والمواد التي تساعد في إعادة ترتيب الجزيئات التي تؤلف اللبنات الأساسية التي تدخل في بناء الطبيعة بحيث يمكن إنتاج أشياء جديدة تماما تختلف عن كل ما هو موجود ومألوف, ويرجع الاهتمام بهذا العلم/التكنولوجيا إلى عام 1959 بفضل عالم الفيزياء الأمريكي فاينمان, ثم انتقل ذلك الاهتمام إلى إريك دركسلر الذي ترتبط النانوتكنولوجي باسمه الآن أكثر من غيره. ورغم ظهور بعض أهم الكتب عن الموضوع في الثمانينيات أيضا فلاتزال الإنسانية في بداية عصر تكنولوجيا النانو, ولاتزال النظريات وطرق البحث في هذا المجال الخصب تتغير وتتجدد وتجذب إليها أعدادا متزايدة من الباحثين والعلماء, بل وأيضا بعض رجال الأعمال والصناعة, كما أفلحت في إثارة اهتمام بعض حكومات الغرب واليابان واستراليا حيث يسود الاعتقاد بأن تكنولوجيا الآلات متناهية الصغر سوف تؤدي إلى قيام ثورة صناعية جديدة تختلف عن كل ما سبق من كل الوجوه, ولاتزال احتمالات وفرص التجديد والاختراع والابتكار في هذا المجال الجديد واسعة ومتنوعة لأن (دنيا النانو) مليئة وزاخرة بالأفكار والتصورات التي تكاد تدخل في باب الخيال العلمي. فهناك على سبيل المثال من يتوقع من بين العلماء أنه في عهد قريب جدا سوف يمكن زرع نوع من الرقائق النانوية في اللحاء المخي لدى الأطفال بحيث تكون محمّلة بمختلف أنواع المعلومات التي سوف يحتاجون إليها في سنوات الدراسة وأن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير طبيعة العملية التعليمية بحيث تقتصر على تفسير المعلومات المخزونة في عقل الطفل بدلا من الانشغال بحفظ واستيعاب تلك المعلومات كما هو حادث الآن, كذلك لن يكون من المستبعد إمكان زراعة بعض تلك الرقائق لتكون بمنزلة مجسات وآلات استشعار تسجل لحظة بلحظة التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية والسيكولوجية التي يتعرض لها المرء في حياته اليومية فتكشفها للآخرين, وإن كان ذلك سوف يترتب عليه كثير من المشاكل بين الناس لأن هذه الرقائق سوف تفضح المشاعر الحقيقية التي يحرص الكثيرون على إخفائها.
وإذا كان فاينمان هو الذي بدأ بتوجيه الاهتمام إلى هذا العلم/ التكنولوجيا عام 1959 على ما ذكرنا فإن دركسلر هو الذي أعطاه اسمه (تكنولوجيا النانو أو علم النانو) وذلك في كتابه عن Engine Of Creation أو جهاز الخلق والإبداع, والذي استخدم فيه تعبير النانو متر وأشار إلى النانو تكنولوجي على أنها قدرة تقنية لم تتحقق في الواقع بعد كل إمكاناتها, ولكنها سوف تجعل من الميسور على العلماء والتكنولوجيين تركيب وبناء المواد ذرة بذرة وجزيئا بجزيء بمنتهى الدقة, بحيث يمكن إقامة وتشييد أنماط جديدة للمادة غير التي أوجدتها الطبيعة.
فالنانوتكنولوجي إذن هي إمكان عام لصنع أو صياغة تكوينات جديدة قد تختلف في الشكل والحجم حسب مواصفات ذرية معقدة. وهذا معناه أن مصطلح نانوتكنولوجي يشير في الأصل إلى نوع التقنية والإمكان وليس إلى حجم المنتج, أي أنه ليس من الضروري أن تكون كل التكوينات الناجمة عن تكنولوجيا النانو تكوينات نانوية متناهية الصغر وإن كانت الأجهزة والأدوات المستخدمة في تجميع هذه التكوينات هي ذاتها تجميعات دقيقة من الذرات تستخدم في التحكم في إعادة ترتيب الذرات والجزيئات التي تؤلف المادة.
ويحتاج تطوير هذه الوسائل التقنية إلى إجراء بحوث متعددة الأبعاد تقتضي التعاون والتآزر بين العلماء والباحثين في عدد من التخصصات المتباينة مثل علماء المواد والهندسة الميكانيكية وبعض فروع العلوم الطبية وعلماء البيولوجيا والفيزياء والكيمياء وغيرهم, حيث يتطلب الأمر معرفة عمليات التفاعل الذري والجزيئي الذي تتوقف عليه إعادة تركيب المواد.
وليس أدل على مدى الاهتمام الذي توليه حكومات الغرب المتقدم للنانوتكنولوجي واستخداماتها في مختلف المجالات من أن الحكومة اليابانية – على سبيل المثال – تعتبر الآلات النانوية هي حجر الزاوية في تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين, ولذا تتولى وزارة الصناعة والتجارة الدولية هناك تمويل تلك البحوث بسخاء, بل وقد تتعاون في ذلك مع كثير من الشركات والأعمال الخاصة التي يهمها تطوير تلك التكنولوجيا لعائدها الاقتصادي الضخم.
كذلك تهتم بعض الجامعات الأوربية مثل جامعة برمنجهام في بريطانيا وجامعة التكنولوجيا في الدنمارك بإجراء البحوث المشتركة في هذا المجال, كما يعقد في أوربا مؤتمر سنوي منذ ثلاثة أو أربعة أعوام حول استخدامات النانوتكنولوجي المختلفة, وتجذب هذه المؤتمرات إليها مئات العلماء والباحثين والمهتمين بالتطبيقات العملية للنانو في الصناعة وتنظيم العمل. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن إحدى عشرة إدارة حكومية أو هيئة بحثية تتولى تمويل بحوث نانوتكنولوجيا الجزيئات, وتشمل هذه الهيئات مراكز الصحة القومية وهيئة بحوث الفضاء وإدارات الطاقة والدفاع, مما يشير إلى طبيعة هذه البحوث المتعددة الجوانب والأبعاد ومجالات استخدامها والإفادة منها لتأمين حياة الفرد وسلامة المجتمع.
ويثير هذا الاهتمام البالغ بتطوير تكنولوجيا الآلات متناهية الصغر عددا من التساؤلات حول الآثار الاجتماعية والأخلاقية التي قد تترتب على اتساع مجالات تسخير هذه التقنيات المتقدمة في مجال الصناعة وتنظيم العمل والدفاع القومي وما إليها, وهل تعطي الهيئات والإدارات والمراكز المعنية بتقدم هذه البحوث ما تستحقه المسألة من عناية واهتمام على المستوى الإنساني البحت, وذلك على اعتبار أن أي تقدم علمي نظري أو تطبيقي في مجال التكنولوجيا لا بد أن يكون له مردود اجتماعي سلبي أو إيجابي حسب اتجاه البحث نفسه والهدف منه ومجال استخدام النتائج التي توصل إليها.
تطلعات ومخاوف
والواقع أن عددا من علماء الاجتماع والمفكرين الذين يتابعون في الخارج هذه التطورات يحرصون على رصد الجهود التي تبذلها مراكز البحث المتخصصة لتعرف الآثار الاجتماعية المباشرة أو الجانبية التي يمكن أن تنجم في المستقبل عن انتشار تلك التقنيات الدقيقة, وهذا هو ما يفعله – على سبيل المثال – (معهد التوقعات المستقبلية) الملحق بجامعة سوينبرن في استراليا الذي يعنى – حسب ما تذكر النشرات الصادرة عنه – بأن تحقق التطورات النانوتكنولوجية أكبر قدر من السعادة والرفاهية للمجتمع الإنساني وتحسين أوضاع البشر على أوسع نطاق ممكن, وأنه يعمل على تسخير تلك التقنيات للارتقاء بقدرات الإنسان أكثر مما يعنى بالمكاسب والفوائد العملية الضيقة والمباشرة التي يمكن الحصول عليها من إنجازات هذه التكنولوجيا. ولكن هذه كلها مجرد تطلعات وأفكار عامة وغير محددة, ومع ذلك ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لأن جهود البحث العلمي في مجال النانوتكنولوجي لا تزال في بداياتها (نسبيا) وأنه في الوقت الذي تحقق فيه إنجازات مؤثرة سوف تظهر بشكل أوضح المشكلات الاجتماعية المتصلة بها وحينئذ يمكن مواجهتها على أرض الواقع بطريقة فعالة.
بل إن كتاب دركسلر الذي سبقت الإشارة إليه يخصص أجزاء كبيرة منه لعرض المشكلات الاجتماعية التي يحتمل ظهورها نتيجة لانتشار استخدام تلك التقنيات الدقيقة في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي, ويحاول تبيين المسارات التي قد تسير فيها العلاقات الاجتماعية نتيجة للتعامل مع هذه التقنيات, كما أن مجلة محترمة ومتخصصة مثل (النانوتكنولوجي ماجازين) تخصص بابا منفردا لعرض المشكلات الاجتماعية المتوقع ظهورها وتطلق على هذا الباب اسما طريفا ومعبرا هو (مجتمع النانو).
ولقد بلغ من الاهتمام بالجوانب والآثار الاجتماعية التي سوف تترتب على تطور وتقدم المنجزات في مجال النانو تكنولوجي المختلفة أن جامعة رايس بالولايات المتحدة عقدت في أكتوبر الماضي 2002 مؤتمرا عن (أيام النانو) عولجت فيه كثير من المشكلات الاجتماعية والقانونية والتنظيمية التي سوف يؤدي إلى ظهورها على السطح انتشار استخدام تلك التقنيات.
وكان من أهم الموضوعات التي تطرق إليها أعضاء المؤتمر الآثار البيئية والبيولوجية والقانونية التي سوف تترتب على انتقال تلك التقنيات من المعمل أو المختبر إلى السوق بحيث تكون في متناول الجمهور العادي, وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتوصل إلى تلك التقنيات واستعمالها والإفادة منها في مجالات الطب مثلا والطاقة والهندسة الوراثية والكيمياء الحيوية بل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وكثير من مظاهر الحياة في المجتمع الصناعي المتقدم, ومدى مراعاة هذه الحقوق إذا انتشرت هذه التقنيات في مجتمعات العالم الثالث التي لم تسهم بأي نصيب في تلك البحوث. وإثارة مشكلة حقوق الملكية في مثل هذه البحوث الدقيقة تنطوي على مخاطر انقسام العالم من جديد إلى الوضع الذي كان عليه أيام الاستعمار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, إذ سوف ينقسم العالم الآن إلى الدول التي تملك والدول التي لا تملك هذه التكنولوجيات, وبالتالي دول الغرب المتقدم التي تعرف كيف تستغل دول العالم الثالث المتخلفة كمصدر للمواد الخام الرخيصة وكسوق لتصريف المنتجات.
وقد يكون الحديث عن الأخطار البيئية سابقا لأوانه الآن. ولكن المشاهد هو أن الاتجاه العام هو نحو العمل على تصغير حجم الآلات والأدوات والأجهزة مع العمل على تحسين أدائها والارتقاء بجودتها وإمكاناتها وتنويع استخداماتها, بحيث يمكن أن تؤدي أكثر من وظيفة واحدة في الوقت نفسه, وهذا يساعد على سهولة الاستعمال بالإضافة إلى رخص الثمن والتقليل من احتمالات تلوث البيئة. والطريف بعد هذا كله أن ثمة مناقشات جادة في الخارج حول إذا ما كان الوقت مناسبا للبحث في إمكان تطبيق اتفاقية جنيف حول تحريم استخدام الأسلحة غير التقليدية على أنواع الأسلحة التي سوف يعتمد إنتاجها على النانوتكنولوجي, ورغم خطورة هذه المسألة فإن مناقشتها في مجتمعات العالم الثالث قد تكون أدخل في باب الترف.
أحمد أبو زيد
 آفاق علمية وتربوية موقع متخصص بالثقافة العلمية والتربوية
آفاق علمية وتربوية موقع متخصص بالثقافة العلمية والتربوية