إعداد : قاسم محمد يوسف ابراهيم
من المسلم به أن الإنسان مهما كانت ظروفه وميوله وقدراته ، بحاجة إلى تعلم وتعليم ، فعمليتا التعلم والتعليم ضروريتان للإنسان ، ملازمتان له ، يأخذ بهما منذ بداية عمره ، أي منذ مرحلة الرضاعة ؛ فيتعلم الصياح أو الضحك ، أو الإيماء أو البكاء ، كي يعبر عن حاجة ملحة ، أو ليبتعد عن خطر يلم به أو يتوقعه،. وبعدها يتدرج في التعلم في مرحلة الطفولة ، ومن بعدها المراهقة ، ثم الشباب … الخ .
ولقد كانت عمليتا التعلم والتعليم مرتبطتين ببعضهما ارتباطا وثيقا ، حتى كان من الصعب تصور أن يحدث تعلم دون وجود معلم ، بيد أن ظهور التكنولوجيا ، وما نجم عنها من أدوات وآلات ، جعلت الكثيرين يعتقدون بتراجع عملية التعليم ، ويتحسرون على تقلص وانحسار دور المعلم ، بيد أنهم في اعتقادهم هذا يجانبون الحقيقة ، فالتكنولوجيا لم تزل دور المعلم ، بل دعمته وجعلته دورة مميزة يستلزم توافر مهارات وكفايات معينة ، ذلك لأن التكنولوجيا كلفت المعلم القيام بأدوار جديدة ، وفرضت عليه جهودا عديدة ، مع التطور التكنولوجي الذي حدث ، خرجت وظيفة المعلم عن دورها التقليدي ، وأصبحت له وظائف جديدة .
وقبل أن نسلط الضوء على الدور الجديد للمعلم ، نرى لزاما علينا أن نوضح أو نستعيد الدور التقليدي للمعلم ، لنرى إلى أي مدى استطاعت تكنولوجيا التربية أن تغير من دوره .
المعلم في دوره التقليدي :
كان المعلم ذاته يرى أن وظيفته الأساسية في الغالب هي : نقل المعلومات إلى أذهان المتعلمين ، مع التقيد التام بما نص المنهج عليه من الموضوعات ، وما ورد في الكتب المدرسية المقررة من معلومات عن هذه الموضوعات .
وبما أن إتقان هذه المعلومات كان غاية في ذاته ، فقد كان المعلم يعني بهذا الإتقان أكثر من عنايته بقيمة المعلومات عند المتعلم . وفي معظم الحالات كان هذا يؤدي بالمعلم إلى تشجيع التنافس بين المتعلمين في دراسة المواد المقررة ، بدلا من تدريبهم على التعاون فيما بينهم للوصول إلى أهداف مشتركة ، وبدلا من إتاحة الفرص المتنوعة أمامهم للقيام بأوجه نشاط مختلفة تساعد على نموهم المتكامل المنشود ، والإهتمام بإتقان المادة الدراسية جعل المعلم في الغالب يحدد لتلاميذه ما يستذكرونه في الكتاب المقرر أولا بأول ، كما جعله يحدد لهم أيضا مقدار العناية التي يوجهونها إلى كل جزء يستذكرونه .
“وكان مدرسون كثيرون يدربون تلاميذهم على أنواع الأسئلة التي ترد في الإختبارات ، وطريقة الإجابة عنها ، كما قلل من اعتماد التلاميذ على أنفسهم ، وجعل كثيرين منهم لا يقبلون على معالجة أي أمر من الأمور إلا إذا أخذوا عنه تعليمات منفصلة ، فضعفت ثقتهم بأنفسهم، وساعد هذا أيضا على شعور التلاميذ أن إتقان المادة الدراسية والنجاح في الإمتحان هو هدف المدرسة الإسمي”.
وصار المعلمون يتبارون في استخدام الوسائل التي تساعد المتعلمين على إتقان ما حدد لهم في المنهج من حقائق ومعلومات ، ومن بين هذه الوسائل تلخيص مواد الدراسة ، وضغطها في كتيبات أو مذكرات لتكون خلاصة سهلة التناول ، كما يقلل من التعلم الذاتي ، وأصبح معظمهم لا يقبل على تحمل المسؤولية بمعناها الصحيح ، وقل ميلهم إلى البحث والإطلاع . إضافة لذلك ، لم يكن المعلم مستعدا لتشجيع التلاميذ على تقديم اقتراحات خاصة بما يدرسونه ، وإذا قدم أحدهم اقتراح ، فإن ذلك يعد نوعا من الجرأة ، وخروج على الحدود المرعية ، ومعنى هذا حرمان التلاميذ من التدريب على التنظيم وربط الأفكار والمعلومات بعضها ببعض، وحرمانهم أيضا من التدريب على النقد البناء .
وكل الحالات سالفة الذكر ، جعلت المعلم لا ينتظر من تلاميذه إلا أن يستقروا في أماكنهم هادئين تماما ، ليتمكنوا من استقبال ما يلقيه عليهم من معرفة وتعليمات ، إذ كان المعلم الماهر هو الذي يستطيع جعل تلاميذه هادئين تماما في أماكنهم دون أي صوت من جانبهم أو حركة أثناء الدرس .
– التعليم المبرمج :
إن ظهور التعليم المبرمج في الخمسينيات من هذا القرن ، بذل كثيرا من المفاهيم التربوية السائدة ، ومن بينها مفهوم “الوسائل التعليمية”، إذ ” أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدارس قادر على أن يتعلم بمفرده إذ عرضت المادة التعليمية عليه بطريقة تسمح له بالتفاعل المباشر بينه وبينها .
كما أثبت التعليم المبرمج أن مواقف التعلم لا تقتضي بالضرورة وجود معلم ، ولذلك اتجه اهتمام التربويين إلى عملية التعليم لا التدريس”.
الأمر الذي أدى إلى تخوف المعلمين من التعليم المبرمج ومن الآلات التعليمية ، فذهب بعضهم إلى القول : “بأن التعليم المبرمج سوف يسهم في نشر البطالة بين من أعدوا لمهمة التعليم ، وهم كثيرون “.
وذهب آخرون إلى أن التعليم المبرمج ” سيقضي على مهنة التدريس كلها” .
وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين المتخوفين من التعليم المبرمج ، اعتبروه مجرد استخدام للآلات في التدريس لتحل محل المعلم ، وهذا ما أثار الخوف عندهم .
اعتماد التكنولوجيا .. هل ألغي دور المعلم ؟
إذا نظرنا إلى التكنولوجيا التربوية على أنها : “طريقة في التفكير ، فضلا عن أنها منهج في العمل ، وأسلوب في حل المشكلات يعتمد في ذلك على اتباع مخطط منهجي ، أو أسلوب النظام لتحقيق الأهداف ، ويتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معا بقصد تحقيق أهداف تربوية محددة” .
وإذا نظرنا إليها على أنها : “برنامج للعمل والممارسة اختيرت مكوناته ورتبت ترتيبة محددة في ضوء منظومة معرفية سلوكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق العلمي” .
وإذا فهمناها على أنها : “تطبيق المعرفة في تصميم وتنفيذ وتقويم النظم التربوية ” ، أتت إجابة السؤال الذي طرحناه سابقا ، بالنفي ، فالتكنولوجيا التربوية لم تلغ دور المعلم ، بل غيرت دوره ، ومنحته أدوارة جديدة يمكن أن نتعرض لها ونعرضها في النقاط الآتية :
– دوره كوسيط تعليمي ومنظم للتواصل :
لقد كان ينظر إلى العملية التعليمية على أنها : عملية اتصال طرفاها المعلم (مرسل) والتلميذ (مستقل) ، يتم فيها نقل المعرفة (الرسالة) عن طريق (وسيط) تختلف أنواعه . ولكن مثل هذا التحديد والفصل بين أدوار العناصر الأربعة لعملية الاتصال لا يتمشى مع النظرة الحديثة للتربية التي تعنى بتكامل عملية الاتصال .
فالوسائط هي ذاتها قنوات أساسية لتوصيل المادة الدراسية ، والعنصر الوسيط قد يكون في نفس الوقت هو المرسل (المعلم) ، فالمعلم في ظل نظم الوسائط لم يعد بالضرورة ( مرسلا ) ، بمعنى آخر لم يعد المعلم ناقلا للمعرفة أو شارحا لها فحسب ، بل أصبح دوره كوسيط تعليمي يقتصر على الأعمال التي لا يمكن لغيره من الوسائط أداءها بنفس الكفاءة” ، ومن ذلك سعيه لتنظيم التواصل الفعال بينه وبين تلاميذه .
– دوره كمعد للأهداف :
فهو معني بتحديد الأهداف السلوكية على شكل نتاجات تعليمية منتظرة ، على أن تكون مرتبطة بالأهداف التربوية العامة .
– دوره كمشخص :
ولكي يسهل المعلم أداء مهمته ، كما يسهل عملية التعلم عند طلابه ، ويجعل العملية التعليمية أكثر نجاعة ، يقوم المعلم بالتعرف على خصائص طلابه. وتحديدها ، لأن ذلك يعينه على فهم طبيعة المتعلمين الذين يتعامل معهم ” فيحدد نواحي القوة والضعف عندهم ، ومستوى القدرة على التعلم لدى كل منهم “.
ويقوم المعلم بعمليات تشخيصية عدة منها :
أ- تشخيص مسحي : ويقوم المعلم فيه بعملية غربلة صفية يتعرف فيها على القادرين من طلابه على إنجاز الأهداف التعليمية الموضوعة، مستخدمة في ذلك الاختبارات التحصيلية ، واختبارات القدرات العقلية ، وراجعا كذلك إلى ملفات الطلاب للوقوف على مستواهم الثقافي والإقتصادي والإجتماعي ، وسجلهم التراكمي.
ب – تشخيص محدد : يتعرف فيه على الفروق الفردية التي تسبب الضعف التحصيلي عند بعض الطلاب .
ج – تشخيص مركز : يتعرف فيه على من يحتاج إلى برامج علاجية وتعليمية خاصة ، مستخدما في ذلك العديد من الاختبارات للوقوف على أسباب التخلف ومظاهر العلاج وطرقه .
ويتمثل دور المعلم هنا في : “الأخذ بيد الضعيف ليضعه على طريق الفهم الصحيح ، وعلى طريق الثقة بالنفس ، وفي نفس الوقت توجيه القوي المتمكن نحو المزيد من القراءات والبحوث ، ونحو مزيد من الإطلاع”.
– دوره كمصمم برامج :
أصبح المعلم مخططا لخبرات وأنشطة تعليمية ترتبط بالأهداف المخططة ، وتناسب مستوى المتعلمين وطرق تفكيرهم ، وتسهم إسهاما فعالا في مساعدتهم على بلوغ الأهداف التعليمية . كما أصبح المعلم مسؤولا عن إعداد المواد التعليمية اللازمة ، كالمجمعات التعليمية ، ورزم التعلم الذاتي ؛ ليتمكن الطلبة من ممارسة عملية التعلم .
ولكي يصمم المعلم برنامجا لابد له من : ” أن يحدد السلوك النهائي ، أي ما يتعلم ، ثم ينبغي أن يرتب المصطلحات والحقائق والقوانين في تسلسل ؛ ليؤدي بالمتعلم إلى السلوك النهائي المرغوب فيه ، وهذا يتطلب أن تكون الخطوات من الصغر بحيث يصل تواتر التعزيز إلى حده الأقصى” .
– دوره كمخطط وموجه للعملية التعليمية التعلمية :
وذلك بإتباعه طريقة منهجية منظمة تمكنه من ضبط المثيرات (المادة التعليمية والحوادث التعزيزية (التغذية الراجعة) بشكل دقيق جدة ، ويتم ذلك عن طريق تجزئة المادة التعليمية إلى وحدات بسيطة وتقويمها بشكل متسلسل ، بحيث يستجيب كل متعلم لكل وحدة من هذه الوحدات ، ثم يزود مباشرة بالتغذية الراجعة للتأكد من صحة استجابته أو تعديلها ، إذا كانت على نحو غير مرغوب فيه .
ولا شك بأن هذه الطريقة تقود المتعلم تدريجيا إلى أداء السلوك المرغوب فيه ، وتجعله أكثر قدرة على التعلم كلما تقدم في تنفيذ البرنامج التعليمي ، لأن تعزيز كل استجابة صحيحة على حدة ، يزود المتعلم بمزيد من الفرص للإستجابة للوحدات التالية بشكل صحيح ، ويقوي لديه دافعية التعلم والرغية في النجاج”.
– دوره كمهندس للسلوك وضابط لبيئة التعلم :
ودور المعلم هنا لا يقتصر على تحليل سلوك المتعلم ومن ثم تعديله ، وإنما يتعدى ذلك ليشمل هندسة سلوكه ، وذلك عن طريق “ترتيب بيئة التعلم ، بحيث يحصل المتعلم على السلوك المراد”.
ومن الواضح أن ثمة اتصالات بين هندسة السلوك ، وتحليل السلوك أو تعديله ، من حيث مدى اهتمام مهندس السلوك بشكل أكبر بمباديء التعزيز . كذلك فإن العمليات التي يقوم بها مهندس السلوك أثناء تصميمه للبرنامج ، وإدارته الشروط التعزيز ، وقيامه بعمليات تقويمية منظمة بقصد الإطلاع على تقدم المتعلمين وتحسنهم ، كل ذلك يؤدي إلى التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تعديل . وبعبارة أخرى يمكن القول : إن هندسة السلوك تقود وتؤدي إلى تعديل السلوك .
ويرى لويد هوم وهو أحد زملاء سكنر أن هندسة السلوك ” تجمع بين أمرين هما : تكنولوجيا السيطرة على شروط التعزيز ، وتكنولوجيا السيطرة على المثير”.
– دوره كمهندس اجتماعي :
فهو يشجع التفاعل بين أفراد الجماعة ، ويستثير الإتصال بين التلاميذ ، ويتعرف على حقيقة أن البشر مخلوقات اجتماعية تنمو وتتطور من خلال التفاعل في مواقف اجتماعية ذات معنى” .
– دوره كموفر للتسهيلات اللازمة للتعلم :
فهو ” يحدد امکانات مختلف مصادر التعلم ، ويساعد التلاميذ على اختيار البدائل التعليمية المناسبة ، ومن ثم يسهل تحقيق أهداف التعلم “.
– دوره كمستشار :
يتعاون مع الآباء ، ومع زملائه من المعلمين ، وكذلك مع المجتمع المحلي ، من أجل تنظيم التعلم للتلاميذ .
– دوره كمتخصص في الوسائل التعليمية :
حيث يكون قادرة على استخدامها ، وصيانتها ، وعارفة بمصادرها ، وقادرا كذلك على تقويم صلتها بالأهداف التدريسية .
– دوره كباحث ومجدد :
ونقصد بذلك : أن يكون المعلم قادرا على التنظير من خلال ما يقوم به من ممارسات ، أو أن يفكر بطريقة منطقية ناقدة في كل ما يقوم به من أنشطة أو أعمال . ويحتاج المعلم لممارسة دوره كباحث في الميدان إلى مساندة وتوجيه من قبل مسؤولية ، مع إتاحة الفرص له للتجريب والابتكار والبحث عن أسباب الظواهر والمشكلات ، والقيام بتجريب ما يراه مناسبا للعلاج أو التطوير . فدور المعلم هنا لا يقتصر على التشخيص ووضع اليد على مواطن القصور أو النواحي السلبية كما ذكرنا سابقا ، بل يمتد دوره ليكون قادرة على وضع التصورات الكفيلة بالعلاج السليم ، ووضعها موضع التنفيذ .
– دوره كمقوم للنتائج التعليمية :
فالمعلم هو الراصد لكل تلك العمليات ، والمقوم لها ؛ للتأكد والتحقق من سلامة الخطوات التي أجراها ، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف الموضوعة ، وبلوغ النتاجات المنتظرة ، ويراعى في ذلك حسن تخطيطه لبرنامجه ، حيث يتقدم فيه خطوة خطوة بتعزيز سلسلة التقاربات المتجهة نحو السلوك النهائي المرغوب فيه ، والموصلة إليه . كما يراعي فاعلية أوقات التعزيز وعدد مراته .
عندما احتج منتقدو سکنر على برنامجه قائلين : إن الآلات التعليمية سوف تحل محل المعلمين ، ” رد عليهم رافضة هذه الفكرة ، ومبينا أن الآلات التعليمية سوف تحسن موقف المعلم المالي لأنها ستمكنه من أن يدرس مواد أكثر لأعداد أكبر من التلاميذ ، وفي مقابل زيادة إنتاجيته ، يستطيع أن يسأل المجتمع ، ويطالبه بتحسين ظروفه الاقتصادية “. ويشير سكنر هنا إلى حقيقة هي : أن رواتب المعلمين لم تلاحق رواتب العاملين بمهن أخرى بسبب أن إنتاجيتهم لم تزد بنفس المعدل ، وأن كثيرا من المعلمين في الوقت الحاضر لا تزيد إنتاجيتهم عن المعلمين منذ قرن من الزمان “.
ونحن وإن كنا نتحفظ ، ولا نأخذ بكل أقوال سكنر تلك ، وذلك لوجود محكات كثيرة للإنتاجية وكيفية قياسها : أبعدد التلاميذ الذين نعلمهم ؟ أم بنسب من ينجحون في الإختبارات ؟ أم بنسب من يواصلون دراسة الموضوع بأنفسهم ؟
نقول : إن كنا لا نتفق مع سكنر في كل ما قاله ، إلا أننا نوافقه في ” أن التكنولوجيا لم تلغ دور المعلم “، بل جعلت له دورة مميزة ، بل أدوارة إضافية ، لا يمكن لأي كان أن يمارسها ، بل ينبغي ألا يتصدى لها إلا من أوتي حظا من الموهبة والدراية ، وقدرا من المعرفة والتدريب والخبرة .
وفي ظل أدوار المعلم الجديدة تلك ، نوافق سكنر أيضا في دعوته المعلم للمطالبة بتحسين موقفه المالي .
وفي نهاية المطاف : قد يبدو دور المعلم في ظل الصورة التي رسمتها له التكنولوجيا رائعة ، إلا أننا نرى أنه يصعب على المعلم – منفردة – ممارسة أدواره جميعها بالفاعلية والكفاءة المنشودتين .
 آفاق علمية وتربوية موقع متخصص بالثقافة العلمية والتربوية
آفاق علمية وتربوية موقع متخصص بالثقافة العلمية والتربوية
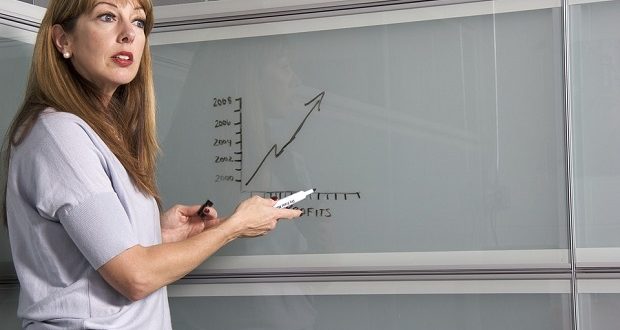




المعلم دائما هو المحرك الأول والفاعل في العلمية التربوية ونجاحة نجاح للتربية في اي دولة
اشكركم
الشكر لكم على مقال دور المعلم في عصر التكنولوجيا
تحياتي لكاتب المقال